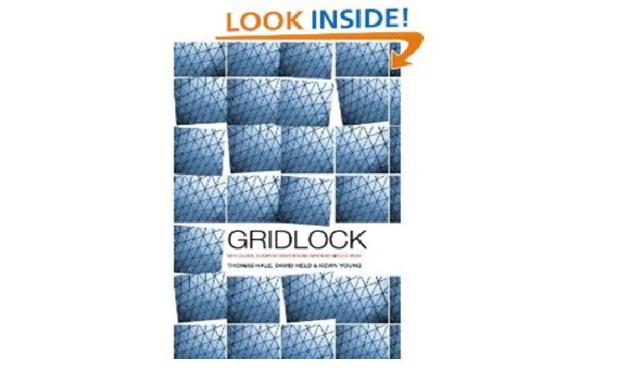تتوقف طروحات هذا الكتاب عند فصلين أساسيين من المشهد العالمي – الكوكبي الراهن، يتعلق أولهما بالحقبة الزمنية التي أعقبت مباشرة انتهاء الحرب العالمية الثانية في منتصف الأربعينيات الماضية.
ومن ثم مطلع عقد، وهي المرحلة التي شهدت – كما يوضح الكتاب- ميلاد وديناميات منظومة النشاط الدولي مجسدة في مؤسسات الأمم المتحدة بكل ما احتوته من وكالات متخصصة، ومن برامج تقنية ومنظمات دولية وصناديق للتمويل.
وعلى مدار حقبة الحرب الباردة التي امتدت حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، ثبت أن هذه المؤسسات العالمية لم تستطع أن تحول دون وقوع مشكلات الاقتصاد والتخلف والانقسام العالمي، فضلاً عن مشكلات البيئة الكوكبية التي باتت تشكل تحديات حقيقية أمام الدول والشعوب، إضافة إلى مشكلات الإمعان في التسلح – النووي بشكل خاص.
أما المشهد الثاني الذي يتوقف عنده مؤلفو هذا الكتاب، فيحمل عنوان «العولمة»، حيث يؤكدون على ضرورة أن تكون هي النهج الأمثل الذي ينبغي اتباعه في المرحلة الراهنة، وفي ضوء ما آلت إليه ظروف وأوضاع العالم – وخاصة مع بدايات الألفية الثالثة – حيث تأكدت ظاهرة الاعتماد المتبادل، ثم باعتبار أن المشكلات التي أصبح البشر يواجهونها في الوقت الحالي باتت تتسم بطابع كوكبي.
في اللغة الإنجليزية المعاصرة – الاستعمال الأميركي – بالذات يستخدمون لفظة غريدلوك (Gridlock).
وبعدها يحار المترجمون والمعرّبون في نقلها إلى العربية، ونحار معهم بطبيعة الحال، وإن كنا نتصور – من باب الاجتهاد ليس إلا- أنها يمكن أن ترادف المعنى الآتي: الطريق المسدود (من فرط الازدحام واختلاط الحابل بالنابل، كما قد نقول).
أهل الاختصاص في التخطيط الحضري مثلاً يلجؤون إلى اللفظة سالفة الذكر حين يريدون تصوير حالة الساحة أو الميدان – أي ساحة وأي ميدان – عندما تتكاثف أعداد المركبات من كل نوع وتنعدم المسافات الفاصلة في ما بينها.
فإذا بالجميع عاجزون عن التحرك، وإذا بالموقع بكامله يصاب بما يوصف بأنه حالة من الشلل المروري، حيث المشكلة ماثلة، ولكن كل الأطراف عاجزة عن التماس المخرج أو إيجاد الحل، لأن طريق هذا الحل مسدود.. مسدود.
هذا هو ما قصده مؤلفو الكتاب الذي نعايشه في ما يلي من سطور. وهم ثلاثة من الباحثين الواعدين من أساتذة الجامعات في إنجلترا وأميركا، ويأتي في صدارتهم الدكتور توماس هيل، الأستاذ في جامعة أكسفورد الإنجليزية العريقة.
وليس صدفة – فيما نتصور – أن اختار هذا الثلاثي الأكاديمي عنواناً لكتابهم يقول بما يلي: «الطريق المسدود: لماذا يواجه التعاون العالمي مصير الفشل بينما نظل في مسيس الحاجة إليه».
صدر هذا الكتاب في شهر يونيو الماضي، وتشاء المصادفات أن يتزامن صدوره مع كتاب آخر أصدرته جامعة أكسفورد بدورها، وهو من تأليف أكاديمي شاب آخر هو الدكتور إيان غولدن، وقد اختار لكتابه عنواناً يطرح التساؤل السابق نفسه، ولو في مجال مغاير.
والعنوان الآخر هو: «الدول المنقسمة: لماذا تواجه الحوكمة العالمية الفشل، وماذا يمكن أن نقوم به في هذا المضمار؟ أسئلة تطلب إجابات».
وفيما جاء صدور هذين الكتابين ضرباً من المصادفة، كما ألمحنا، لكن الذي يجمع بينهما في تصورنا هو علامتا الاستفهام، صيغتا التساؤل التي باتت منطلقاً لصفوة الدارسين والباحثين، وخاصة من الأجيال الطالعة، إزاء ما أصبح يتجلى أمامهم من أوضاع يتسم بها عالمنا، خلال هذه السنوات الاستهلالية من القرن الجديد.
وهي أوضاع باتت في تصورنا، وفي رأيهم تطرح من الأسئلة الحائرة أكثر مما تطرح من الإجابات الشافية أو الحلول المتاحة أو المعقولة لما أصبح عالمنا يكابده في المرحلة الراهنة من عقبات ومشكلات.
هؤلاء الباحثون الشبّان يرون أنهم في حالة استشراف للجديد أو الآتي مما قد تَعِد به تطورات المستقبل، لكنهم يعاينون في الوقت ذاته، وبحكم تعقيدات الحالة العالمية – الكوكبية – حقيقة أن هذا الجديد المأمول ما زال بعيداً، عصيّاً على المجيء، وكأنه فجر لا يريد أن تنبلج أنواره كي تبدد ما يحيط عالمنا من دياجير المعضلات.
وهو ما عبرت عنه يوماً كلمات المفكر الإيطالي الأشهر أنطونيو غرامشي (1891- 1937) حين كتب، وهو في محبسه السياسي، يقول: «تتمثل الأزمة بالضبط في حقيقة أن القديم يموت، ولكن الجديد ما زال عاجزاً عن أن يولد».
المهم أن الكتاب يستهل طروحاته ببيان أن عالم ما بعد الحرب الكونية الثانية، وقد بدأ تقريباً مع عقد الخمسينيات، شهد ميلاد العديد من المؤسسات ذات الطابع الدولي، وفي مقدمها منظومة الأمم المتحدة بكل ما تضمّه من منظمات ووكالات متخصصة وصناديق مالية وبرامج محددة المهام، وكلها كانت تهدف بحكم وجودها، فضلاً عن أنشطتها وغاياتها، إلى تشجيع ما أصبح يوصف في ما بعد بأنه أوضاع العولمة.
بيد أن المشكلة تمثلت، وما برحت تتمثل، في أن هذه العولمة أسفرت عن مسؤوليات، وانطوت على تحديات، فيما عجزت هذه المؤسسات ومثيلاتها، سواء على المستوى النظري أو الإقليمي، أو حتى القارّي، عن حلها أو عن التعامل معها.
صحيح، تضيف فصول هذا الكتاب، أن مؤسسات ما بعد الحرب العالمية أسهمت في تحسين أحوال الرفاه في بعض من دول العالم، بل كان الرخاء في بعضها الآخر، وخاصة مع استتباب أوضاع السلام، ولو في ظل الحرب الباردة بين معسكري موسكو وواشنطن.
وصحيح أن انتعشت بفضل تلك المؤسسات – المعولمة إن شئت – عمليات نشر قيم التحول الديمقراطي، وإقرار منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وصحيح أنها ظلت تعمل جاهدة، أو قدر ما استطاعت، على تأثيم وتجريم ما وقع من تعديات على حقوق الإنسان، وما تم ارتكابه من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية (الجينوسايد)، وهو ما تجلي مثلاً في المحاكمات الدولية التي تولّت الفصل في تلك الجرائم ما بين محاكمات نورمبورغ.
أو محاكمات زعماء البلقان، أو محاكمات قادة غرب أفريقيا ومن في حكمهم، إلا أن هذا كله لم يُجد فتيلاً ، كما يقولون، في إصلاح أحوال عالمنا، إذ كان يودع القرن العشرين، ومن ثم يتخذ أولى خطواته – في ظل العولمة – نحو هذا القرن الواحد والعشرين.
بل إن الصورة ازدادت – مع السنوات الأولى من القرن المستجد، وعلى شكل ظواهر فادحة السلبية، يطلق عليها كتابنا الوصف التالي: العوامل الاجتماعية الخارجية التي تستعصي على التعامل الفعال، لأنها تتجاوز قدرات المؤسسات السيادية (الوطنية – الداخلية) من أجل نجاح أو نجاعة مثل هذا التعامل.
وفي مقدم هذه الظواهر – العوامل، ما يلي، على نحو ما تسرد صفحات الكتاب: آفة الإرهاب، ظاهرة الدول الفاشلة (وهي التي تجمع بين سلبيات السلطوية وسياسات النبذ أو الإقصاء على نحو ما يذهب إليه المفكران سيموغلو وجيمس روبنسون في كتابهما الشهير عن أسباب فشل الدول).
ويزيد على هذا، كما تضيف فصول كتابنا أيضاً، ما يصفه مؤلفوه بأنه ظاهرة (أو جريمة) القرصنة الإلكترونية، التي باتت تتعدى على خصوصية البشر، فضلاً عن هتك أسرار الأمن للدول والشعوب، ثم يضاف إلى ذلك أيضاً، ظاهرة السيطرة من جانب قوى عاتية على المؤسسات عبر الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما أصبح يهدد بدوره إمكانية الحوكمة المالية.
حيث لا سبيل للسيطرة على، أو التحكم في مسارات الأموال والثروات، ما بين مصادرها ومنافذها إلى مصارفها ومآلاتها، وبحيث توجه هذه الأموال إلى البناء وليس إلى الهدم، إلى رفاه البشر، صحة وتعليماً وترفيهاً، وأملاً في المستقبل.
وليس إلى ترويع البشر، إرهاباً ودماراً وحرماناً من أي أمل يلوح ويبشر، أو حتى يَعِد بأن غدنا يمكن أن يكون أفضل من يومنا، على نحو ما أنشد الشاعر التركي ناظم حكمت في يوم من الأيام.
البداية من السبعينيات
يرجع مؤلفو هذا الكتاب بجذور هذه التعقيدات التي أصابت العولمة (حتى قبل أن يشيع المصطلح)، إلى عقد السبعينيات من القرن المنصرم، يصفون الحقبة السبعينية بأنها شهدت بداية صعود قوى عالمية جديدة أضيفت بالطبع إلى عالم كان قبل ذلك ثنائي القطبين بين شرق محدد الأيديولوجية تحت الشعار الشيوعي – الاشتراكي – الماركسي، ثم غرب كان بدوره محدد الهوية تحت مسميات المعسكر الغربي.
الحر، الرأسمالي، الأطلسي، إلخ.
وكان بديهياً مع دخول القوى الجديدة عبر الثلث أو الربع الأخير من قرن مضى، أن يضاف إلى خطاب العولمة أصوات واجتهادات ومقولات ودعوات جديدة، بعضها غير مسبوق، وهو ما أدى إلى اضطراب، بل وتشتت مقولات هذا الخطاب بعيداً عن أي روح للاتفاق أو حتى التوافق، ما بالنا بالإجماع.
بل إن هذا الخطاب العولمي المائج بهذا الاختلاف إلى حد الاضطرام والاضطراب، ما لبث أن تخطى مجالات السياسة وأطر الأفكار والعقائد، فكان أن انتقل إلى عوالم الاقتصاد، ومن ثم قضايا البيئة وتغيرات المناخ الكوكبي.
بينما شكلت هذه المستجدات في مجموعها، وكما يؤكد الفصل الثاني من كتابنا، تعقيدات وتحديات نالت كثيراً من ديناميات الطرح العولمي للمشكلات، ومحاولة التماس حلول لها، وخاصة على صعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
العولمة في الألفية الثالثة
هنا يتوقف مؤلفو الكتاب، ونحن على أبواب الفصلين الرابع والخامس (الأخير)، كأنما لالتقاط الأنفاس، ليؤكدوا ما يلي: إن العالم منذ التسعينيات بالذات، ومع هذه السنوات الأربع عشرة من الألفية الثالثة، لا بد أن يعترف بأن ظاهرة العولمة بكل ما جاءت به، عمداً أو مصادفة، وسواء كان ذلك محل قبول أو تردد أو رفض من جانب أي طرف من أطراف كوكبنا – هذه العولمة أصبحت حقيقة واقعة.
وهي من ثم تقوم على أساس محور جوهري، لا بد أن يكون بدوره محل الاهتمام من جانب الأطراف المعنية كافة: هذا المحور تلخصه العبارة المباشرة التالية: الاعتماد المتبادل، وهي عبارة جاءت ترجمةً لمصطلح إنجليزي أصبح ذائعاً بحق في عوالم السياسة والاقتصاد على السواء.
وأياً كان المصطلح، فالشاهد هو ما تخلص إليه مقولات هذا الكتاب على نحو يقول بالتحديد: لا يمكن لأي طرف، أي دولة، أي بلد (ناهيك عن أي قيادة أو أي زعامة)، أن تلتمس حلولاً منفردة لأي مشكلة تصادف الشعوب في عالمنا الراهن، وبمعنى أن لم يعد ممكناً الاقتصار في مقاربة الأزمات على الحلول الداخلية، أو حتى الحلول الإقليمية، الوطنية، القطرية أو الجهوية، كما قد نقول.
المؤلفون في سطور
المؤلف الأول الدكتور توماس هيل، وهو الذي يُنسب إليه الكتاب من باب التعريف أو التبسيط، يعمل زميلاً باحثاً في كلية أصول الحكم بجامعة أكسفورد بإنجلترا.
المؤلف الثاني الدكتور ديفيد هيلد يعمل أستاذاً لعلم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة ديرهام البريطانية.
المؤلف الثالث الدكتور كيفن يونغ هو أستاذ مساعد للعلوم السياسية في جامعة ماساشوستس بالولايات المتحدة.
حصل البروفيسور توماس هيل على الدكتوراه من جامعة برنستون الأميركية. وقبلها درس في كلية لندن الشهيرة للاقتصاد، ومنها حصل على درجة الماجستير.
حقائق في إطار العولمة
يخلص مؤلفو الكتاب إلى تأكيد التماس التوافق وتوخي المصالح المشتركة، مقابل الانفراد وتكريس المصالح المنفردة، حيث لم يعد من سبيل إلى العزلة أو الاستئثار بالرأي، وخاصة في مجالات الأمن، ونزع السلاح والنشاط الاقتصادي ومجابهة ما أصبحت البيئة الكوكبية وتغيرات المناخ تطرحه من مشكلات وتحديات.
العولمة ليست ظاهرة مؤقتة ولا وليدة مرحلة بعينها
يؤكد مؤلفو هذا الكتاب أن العولمة هي ظاهرة العصر، وهي السمة الأساسية للألفية الثالثة. والظاهرة ليست مؤقتة ولا هي وليدة حقبة زمانية ولا تلبث أن تتبدد أو تخفت أو تتلاشي.
تأمل مثلاً في أحوال التأثير والتأثر في عالم الاقتصاد، إنها تتبع نمط لعبة الدومينو: يسقط واحد من أحجار اللعبة، فإذا به يؤثر في تداعي سائر الأحجار المصفوفة واحداً في أثر الآخر.
تأمل أيضاً تنامي وتداعيات ظواهر تغيّر المناخ، انصهار الكيانات الجليدية عند قطبي الكرة الأرضية في شمال وفي جنوب.
تأمل أوضاع قوى وشعوب تمتلك احتياطات الطاقة، ثم أحوال قوى وشعوب تتحرق لهفة للحصول على الطاقة.
في هذا السياق، يؤكد هذا الكتاب على أن القضية ليست مجرد تطوع إزاء التعاون العولمي، حيث التعاون هنا لا يمثل فضيلة مندوباً إليها، كما يقال في تراثنا اللغوي، إن التعاون، التضافر، التآزر أو فلنقل الاعتماد المتبادل أصبح أمراً واجباً – بل هو قضية حياة أو موت، فلا يمكن أن يترك أي بلد وشأنه تحت شعارات عدم التدخل.
لأن كل ما يدور في أي بلد على خريطة عالمنا من شأنه أن يؤثر بحكم الضرورة في سائر ما يحيطه من أقطار.
وما يحفه من مظاهر ترتبط بالجغرافيا أو المناخ أو التضاريس، يستوي في ذلك أنشطة المفاعلات النووية مع الانبعاثات الكربونية المتصاعدة من دخان المصانع المستخدِمة لمصادر الطاقة الأحفورية، بقدر ما يستوي الأمر أيضاً مع ممارسة أنواع الصيد المتجاوز، غير المشروع.
أو هو الصيد الجائر في بحار ومحيطات العالم، بقدر ما يستوي الأمر كذلك عبر استغلال مصادر المياه العذبة من مجاري الأنهار وموارد البحيرات، وهو ما ينبغي أن يتم وفقاً لما يتوصل إليه الفرقاء، أصحاب المصلحة من اتفاقات ومعاهدات تضمن عدالة الشراكة وتحول دون التجاوز أو الإفتات.