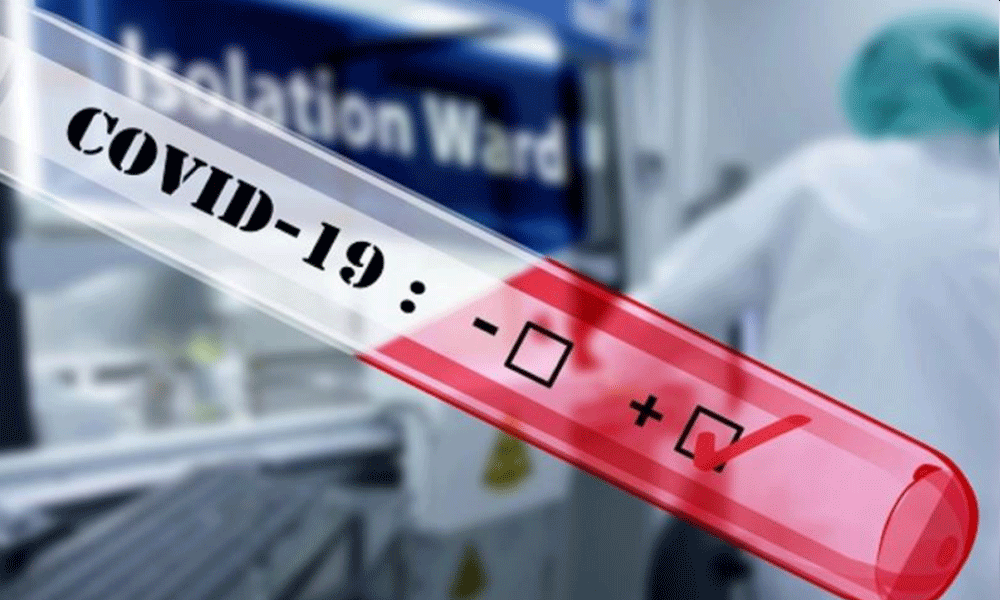كتبت رحيل دندش في جريدة الأخبار:
«كان الأمر مرعبًا. ركنت سيارة الإسعاف الثلثاء تحت منزلنا. تجمّع الناس على الشرفات يراقبون الكائن الفضائي الذي كنته. كان موقفاً غريباً، يصعب وصف الأحاسيس التي رافقته. والأصعب هو نظرات أهلي المستعطفة عندما كان المسعفون ينقلونني إلى مكان الحجر». هكذا يصف حسام لحظات نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي للحجر بعد إصابته بفيروس «كورونا». صحيح أنه تلقّى تعاطفاً كبيراً من المحيطين به خلال فترة مرضه، «فلم تتوقف الاتصالات والرسائل المشجّعة حتى من أشخاص لا أعرفهم». لكن دائماً ثمة منغّصات سببها الخوف الذي عمّ الناس. «فقد تعرّض أهلي لحالة من الحجر الاجتماعي رغم عدم إصابتهم، واستمرّ الخوف مني والمضايقات حتى بعد شفائي ومكوثي في الضيعة»، إذ أن «جارنا عاتب والدتي لدى خروجها من المنزل لاحتمال نقلها للفيروس رغم أنني كنت قد شفيت وخرجت من المستشفى»!
تخطّى لبنان حاجز الـ 50 ألف إصابة منذ تسجيل أول حالة في شباط الماضي. وينصبّ تركيز المعنيين على إبطاء عدّاد الأرقام والحد من التفشي، لكنّ أحداً لا يلتفت إلى جانب لا يقلّ أهمية، وهو كيفية التعاطي مجتمعياً مع المصابين والمشتبه في إصابتهم وذويهم. شهادات المتعافين تكاد تكون متشابهة جداً لناحية التهيّب الذي تعاطى به المحيطون بهم خلال الإصابة وحتى بعد الشفاء التام. كان يكفي ملاك أن تشتبه في أنها مصابة حتى تتأثر علاقتها بصديقتها المقرّبة: «عندما علمت أن أختي خالطت مصابة، حجرت نفسي احتياطاً، لأفاجأ بحالة من الهستيريا تصيب صديقتي التي راحت تتصل بي كل ساعة لتعرف نتيجة فحوصات أختي، وصارت تلومني لأنني أتيت إلى العمل في اليوم نفسه الذي عرفت فيه متأخّرة بأن أختي مخالطة. عشت متوترة الأعصاب حتى ظهرت النتيجة التي جاءت سلبية، لا خوفاً من الإصابة بقدر ما كنت خائفة منها».
هدى، العاملة في مؤسسة إعلامية، تروي كيف أنه «بعدما شُفي زميلنا المصوّر وعاد إلى العمل إثر تعافيه، رفضت زميلتي أن يدخل إلى مكاتبنا رغم أنه كان يرتدي الكمامة». تبرّر خوف الناس المبالغ فيه من المرض بـ«كمية الأخبار التي تنتشر عنه». فالناس «خائفون من الموت ومن الطبيعي أن يتعاطوا بعدائية عندما يشعرون بالقلق».
جزء من هذا الرعب يعود إلى طريقة تعاطي الإعلام مع الجائحة، وتصديره أخبارها بالتركيز على الحذر والوقاية. وهو وإن كان أمراً مطلوباً في تغطية أخبار الجائحة، لكنه قد يأتي بمفاعيل عكسية. فبدل زيادة الوعي ينتشر الخوف واللوم المتبادل والترويج لدعاوى عصابية تطالب بالعزل. وهذا ما كان في أوجه مع بداية تفشي الوباء، عندما أصيب رائد بالفيروس. عدا آلام المرض ووهن الجسد، كانت العزلة التي امتدت شهرين بعد الشفاء المعضلة التي لم يستطع تجاوزها إلى اليوم: «بعد مرور أشهر لا أستطيع النوم جيداً. تلاحقني أحلام مزعجة ووسواس من عودة المرض والابتعاد عمن أحبهم مجدداً». يضيف: «في البداية كنت أقرأ الخوف في عيون من أقابلهم. لم يجر الابتعاد عني بطريقة فجّة، لكن عيونهم كانت تتجمّد لثوانٍ عند رؤيتي».
لم يجر الابتعاد عني بطريقة فجّة، لكنّ عيونهم كانت تتجمّد لثوانٍ عند رؤيتي
الحذر والأخذ بالاحتياطات وأساليب الوقاية أمور مطلوبة وضرورية في مواجهة الفيروس، لكن التعامل معه بطريقة هوسية وعلى أنه وصمة أدى إلى مفاعيل عكسية، أبرزها تأخر الإبلاغ عن الحالات إلا حين تتفاقم لتُنقل إلى المستشفى، ما أدى إلى تفشي الوباء.
والتعامل مع الأمراض عموماً كوصمة أمر غير جديد. البعض يخفي إصابته بالسرطان أو الأيدز مثلاً. تُدارى الإصابة كما لو أنها فضيحة وإهانة، تعرّض صاحبها للنبذ، «لأن الناس ينظرون إلى المرض كما لو أنه عقاب، والعقاب يأتي بعد ذنب، والذنب لا يشرّف صاحبه، وهذا ينجم عنه الخجل والرفض»، بحسب العضو في اللجنة القانونية لمهنة علم النفس في لبنان الدكتورة نازك الخوري. وتلفت إلى أن «في حالة الأمراض المعدية يتعامل البعض مع المريض على أنه هو الفيروس وليس حاملاً له، وبالتالي يشكل خطراً وتهديداً لهم. من هنا تأتي ردات الفعل انطلاقاً من مبدأ حماية الذات». هذا الأمر كان في أوجه مع بداية ظهور الوباء. ومن الطبيعي، بحسب الخوري، اتخاذ الاحتياطات الحمائية، لكن وصم المريض غير طبيعي وغير إنساني، لافتة إلى أن ردود الفعل «المستنفرة» هدأت، مع معرفة طرق انتقال المرض، «فالوعي يسهم في تخفيف القلق والهلع، وباتباع الإرشادات نتجنّب التقاط الفيروس من شخص مصاب، بكل موضوعية وتصرّف علمي ومن دون جرح مشاعر الطرف الآخر».